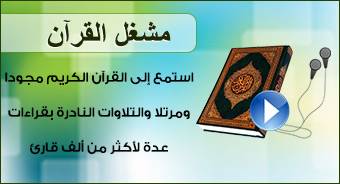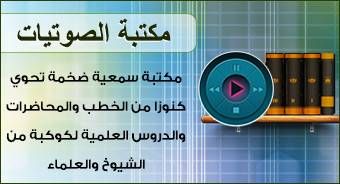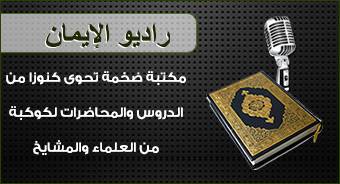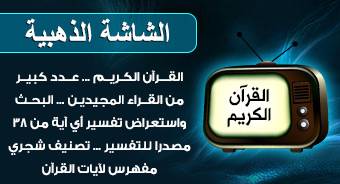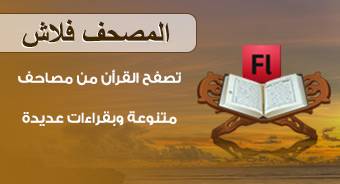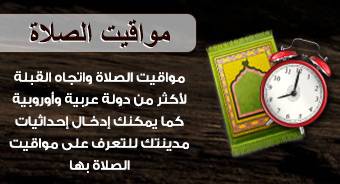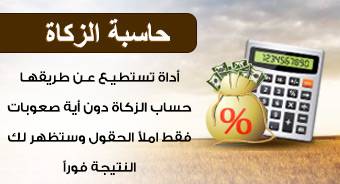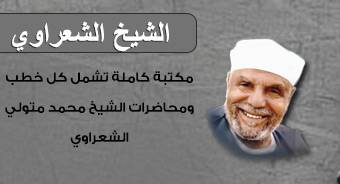|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صبح الأعشى في كتابة الإنشا (نسخة منقحة)
وبمراكش جامع جليل يعرف بالكتبيين، طوله مائة وعشرة أذرع، وعلى بابه ساعات مرتفعة في الهواء خمسين ذراعا، كان يرمى فيها عند انقضاء كل ساعة صنجة زنتها مائة درهم، تتحرك لنزولها أجراس تسمع على بعد، تسمى عندهم بالبحانة. قال في تقويم البلدان: إلا أن الناس أكثروا فيها البساتين فكثر وخمها. قال في الروض المعطار: وقد هجاها أبو القاسم بن أبي عبد الله محمد ابن أيوب بن نوح الغافقي من أهل بلنسية بأبيات أبلغ في ذمها، فقال: [مخلع البسيط] وكانت هذه المدينة دار ملك المرابطين من الملثمين الذين ملكوا بعد بني زيري، ثم الموحدين من بعدهم. قال ابن سعيد: وبينها وبين فاس عشرة أيام.وقال في الروض المعطار: نحو ثمانية أيام. قال: وبينها وبين جبال درن نحو عشرين ميلاً.القاعدة الرابعة: سجلماسة:بكسر السين المهملة وكسر الجيم وسكون اللام وفتح الميم ثم ألف وسين مهملة مفتوحة وهاء في الآخر، وهي مدينة في جنوب الغرب الأقصى في آخر الإقليم الثاني من الأقاليم السبعة. قال ابن سعيد: حيث الطول ثلاث عشرة درجة واثنتان وعشرون دقيقة والعرض ست وعشرون درجة وأربع وعشرون دقيقة.وهي مدينةٌ عظيمةٌ إسلامية، وبينها وبين البحر الرومي خمس عشرة مرحلةً، وليس قبليها ولا غربيها عمرانٌ، وبينها وبين غابة من بلاد السودتن مسيرة شهرين في رمال وجبال قليلة المياه، لا يدخلها إلا الأبل المصبرة على العطش. اختطها يزيد بن الأسود من موالي العرب، وقيل: مدرار بن عبد الله.وكان من أهل الحديث، يقال إنه لقي عكرمة مولى ابن عباس بأفريقية وسمع منه. وكان صاحب ماشية، وكان ينتجع موضع سجلماسة بالصحراء ليرعى به ماشيته، فكان يجتمع إليه أهل تلك الصحراء من مكناسة والبربر، وكانوا يدينون بدين الصفرية من الخوارج، فاجتمع عليه جماعةٌ منهم فلما بلغوا أربعين رجلاً قدموا عليهم يزيد بن الأسود وخلعوا طاعة الخلفاء، واختطوا هذه المدينة سنة أربعين ومائةٍ من الهجرةٍ.ولها اثنا عشر بـ أبا، وهي كثيرة العمارة، كثيرة البساتين، رائقة البقاع، ذات قصور ومنازل رفيعة وعماراتٍ متصلة، على نهر كثير الماء يأتي من جهة المشرق من الصحراء، يزيد في الصيف كزيادة النيل، ويزرع على مائة كما يزرع على ماء النيل، والزرع عليه كثير الأصابة، والمطر عندهم قليل: فإذا كانت السنة كثيرة الأمطار، نبت لهم ما حصدوه في العام السابق من غير بذر، وربما حصدوه عند تناهيه وتركوا أصوله فتنبت ثانياً. ويقال: يزرع بها عاماً ويحصد ثلاثة أعوام، وذلك أن أرضها مشقةٌ، هي بلدةٌ شديدة الحر فإذا يبس الزرع تناثر عند الحصاد ودخل في الشقوق، فإذا كان العام الثاني وعلاه ماء النهر وخرج عنه حرثوه بلا بذر فينبت ما في الشقوق، ويبقى كذلك ثلاث سنين.وقد حكى ابن سعيد: أن هذا الزرع في السنة الأولى يكون قمحاً، وفي باقي السنين سلتاً، وهو حب بين القمح والشعير. وبها الرطب، والتمر، والعنب الكثير، والفواكه الجمة، وليس فيها ذئاب ولا كلاب لأنهم يسمنونها ويأكلونها، وقلما يوجد فيها صحيح العينين، ولا يوجد بها مجذومٌ ولها ثمانية أبواب من أي باب منها خرجت ترى النهر والنخيل وغير ذلك من الشجر، وعليها وعلى جميع بساتينها حائطٌ يمنع غارة العرب مساحته أربعون ميلاً، وثمرها يفضل ثمر سائر بلاد المغرب، حتى يقال: إنه يضاهي الثمر العراقي، وأهلها مياسير، ولها متاجر إلى بلاد السودان، يخرجون إليها بالملح والنحاس والودع، ويرجعون منها بالذهب التبر. قال ابن سعيد: رأيت صكاً لأحدهم على آخر مبلغه أربعون ألف دينار.ولما قدموا عليهم عيسى بن الأسود المقدم ذكره، أقام عليهم أياماً ثم قتلوه سنة خمس وخمسين ومائة، واجتمعوا بعده على كبيرهم أبي القاسم سمكو، بن واسول بن مصلان، بن أبي يزول، بن تافرسين، بن فراديس، بن ونيف، بن مكناس، بن ورصطف، بن يحيى، بن تمصيت، بن ضريس، بن رجيك، بن مادغش، بن بربر. كان أبوه سمكو من أهل العلم ارتحل إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والأكرام فأدرك التابعين، وأخذ عن عكرمة مولى ابن عباس، ومات فجأة سنة سبع وستين ومائة لثنتي عشرة سنةً من ولايته.وكان مع ذلك على مذهب الصفرية، وخطب في عمله للمنصور والمهدي من خلفاء بني العباس.ولما مات مكانه ابنه إلياس بن أبي القاسم وكان يدعى بالوزير ثم انتقضوا عليه سنة أربع وسبعين ومائة فخلعوه.وولي مكانه أخوه اليسع بن أبي القاسم وكنيته أبو منصور، فبنى سور سجلماسة، وشيد بناينها، واختط بها المصانع والقصور لأربع وثلاثين سنة من ولايته. وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلماسة، وسكنها آخر المائة الثانية بعد أن كان يسكن الصحراء وهلك سنة ثمانٍ ومائتين.وولي بعده ابنه مدرار ولقب المنتصر وطال أمد ولايته. وكان له ولدان اسم كل منهم ميمونٌ، فوقع الحرب بينهما ثلاث سنين، ثم كان آخر أمرهما أن غلب أحدهما أخاه وأخرجه من سجلماسة، ثم خلع اباه واستقل بالأمر، وساءت سيرته في الرعية فخلعوه، وأعادوا مدراراً أباه.ثم حدث نفسه بإعادة ابنه ميمونٍ فخلعوه وولوا ابنه ميموناً الآخر، وكان يعرف بالأمير، ومات مدرارٌ إثر ذلك سنة ثلاث وخمسين ومائتين. ومات ميمونٌ سنة ثلاث وستين ومائتين.وولي مكانه ابنه محمد فبقى إلى أن توفي سنة سبعين ومائتين.فولي مكانه اليسع بن المنتصر. وفي أيامه وفد عبيد الله المهدي الفاطمي وابنه أبو القاسم على سجلماسة في خلافة المعتضد العباسي، وكان اليسع على طاعته فبعث المعتضد إليه فقبض عليهما واعتقلهما إلى أن غلب أبو عبد الله الشيعي داعي المهدي بني الأغلب أصحاب أفريقية، فقصد سجلماسة فخرج إليه اليسع في قومه مكناسة، فهزمه أبو عبد الله الشيعي واقتحم عليه البلد، وقتله سنة ست وتسعين ومائتين، واستخرج عبيد الله وابنه من محبسهما، وبايع لعبيد الله المهدي.وولى المهدي على سجلماسة إبراهيم بن غالب المزاتي وانصرف إلى أفريقية، ثم انتقض أهل سجلماسة على واليهم وإبراهيم ومن معه من مكناسة سنة ثمان وتسعين ومائتين.وبايعوا الفتح بن ميمون الأمير ابن مدرار المتقدم ذكره، ولقبه واسول، وهلك قريباً من ولايته على رأس المائة الثالثة.وولي مكانه أخوه أحمد بن ميمون الأمير، واستقام أمره إلى أن زحف مصالة بن حيوس في جموع كتامة ومكنائة إلى المغرب سنة تسع وثلثمائة، فافتتح سجلماسة وقبض على صاحبها أحمد بن ميمون.وولى عليها ابن عمه المعتز بن محمد بن يادن بن مدرار، فلم يلبث أن استبد وتلقب المعتز، وبقي حتى مات سنة إحدى وعشرين وثلثمائة قبل موت المهدي.وولي من بعده ابنه أبو المنتصر محمد بن المعتز فأقام عشراً ثم هلك.وولي من بعده ابنه المنتصر سمكو شهرين، ودبرته جدته لصغره.ثم ثار عليه ابن عمه محمد بن الفتح بن ميمونٍ الأمير وتغلب عليه، وشغل عنه بنو عبيد الله المهدي بفتنة ابن أبي العافية وغيرها، فدعا لنفسه مموهاً بالدعاء لبني العباس وتلقب الشاكر لله، وأخذ بمذاهب أهل السنة ورفض الخارجية، وكان جميع من تقدم من سلفه على رأي الأباضية والصفرية من الخوارج، وضرب السكة باسمه ولقبه، وبقي كذلك حتى فرغ بنو عبيد الله من الفتن، فزحف القائد جوهر أيام المعز لدين الله معد إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلثمائة، فغلب على سجلماسة وملكها وفر محمد بن الفتح عنها، ثم قبض عليه جوهر بعد ذلك وحمله إلى القيروان.فلما انتقض المغرب على العبيدين وفشت فيه دعوة الأمويين بالأندلس، ثار بسجلماسة قائم من ولد الشاكر، وتلقب المنتصر بالله ثم وثب عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتين وخمسين فقتله وقام بالأمر مكانه، وتلقب المعتز بالله وأقام على ذلك مدة، وأمر مكناسة يومئذ قد تداعى إلى الأنحلال، وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب إلى أن زخف خزرون بن فلفول من ملوك مغراوة إلى سجلماسة سنة ست وستين وثلثمائة، وبرز إليه أبو محمد المعتز فهزمه خزرون وقتله واستولى على بلده، وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتابه بالفتح، وكان ذلك لأول حجابة المنصور بن أبي عامر بقرطبة، فعقد لخزرون على سجلماسة، فأقام دعوة هشام في نواحيها، فكانت أول دعوة أقيمت لهم في أمصار المغرب الأقصى، وانقرض أمر مكناسة من المغرب أجمع.وانتقلت الدولة إلى مغرواة وبني يفرن وعقد هشام لخزرون على سجلماسة وأعمالها، وجاءه عهد الخليفة بذلك، وضبطها وقام بأمرها إلى أن هلك.فولي أمر سجلماسة من بعده ابنه وانودين بن خزرون إلى أن غلب زيري ابن مياد على المغرب، فعقد على سلجلماسة لحميد بن فضل المكناسي، وفر وانودين بن خزرون عنها، ثم أعاده عبد الملك إلى سجلماسة بعد ذلك على قطيعة يؤديها إليه، ثم استقل بها من أول سنة تسعين وثلثمائة مقيماً للدعوة الأموية بالأندلس، ورجع المعز بن زيري بولاية المغرب عن المظفر بن أبي عامر، واستثنى عليه ولاية سجلماسة لكونها بيد وانودين، واستفحل ملك وانودين، واستضاف إلى سجلماسة بعض أعمال المغرب ومات.فقام بالأمر بعده ابنه مسعود وانودين إلى أن خرج عبد الله بن ياسين شيخ المرابطين، فقتل ابن وانودين سنة خمس وأربعين وأربعمائة، ثم ملك سلجماسة بعد ذلك سنة ست وأربعين، ودخلت في ملك المرابطين لأول أمرهم، وانقرضت دولة بني خزرون منها، وتداولها من بعدهم من ملوك الموحدين، ثم ملك بني مرين على ما سيأتي ذكره في الكلام على ملوك الغرب الأقصى إن شاء الله تعالى.وأما ما اشتملت عليه هذه المملكة من المدن المشهورة.فمنها مدينة آسفي بفتح الهمزة ومدها وكسر السين المهملة والفاء وياء مثناة تحت في آخرها.وهي مدينة واقعة في الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة قال ابن سعيد: حيث الطول سبع درج، والعرض ثلاثون درجة، قال في تقويم البلدان: وهي من عمل دكالة، وهي كورة عظيمة من أعمال المراكش، قال ابن سعيد: وهي على جون من البحر في البر، في مستوٍ من الأرض، وهي فرضة مراكش، وبينها وبين مراكش أربعة أيام، وأرضها كثيرة الحجر، وليس بها ماء الأأ من المطر، وماؤها النبع غير عذب، وبساتينها تسقى على الدواليب، وكرومها على باب البلد.قال الشيخ عبد الواحد: وهي تشبه حماة ودونها في القدر، ولكن ليس لها نهري يجري.ومنها سلا. بفتح السين واللام وفي آخرها ألف، وهي مدينة من الغرب الأقصى في آخر الإقليم الثالث.قال ابن سعيد: حيث الطول سبع درج وعشر دقائق والعرض ثلاث وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة وهي مدينة قديمة في غربيها البحر المحيط وفي جنوبيها نهر عظيم يصب في البحر المحيط والبساتين والكروم.وبني عبد المؤمن أمامها من الشط الجنوبي على النهر والبحر المحيط قصراً عظيماً، وبنى خاصته حوله المنازل فصارت مدينة عظيمة سماها المهدية.وسلا متوسطة بين بلاد المغرب الأقصى قريبةٌ من الأندلس، وهي مدينةٌ كثيرة الرخاء، ولها معاملة كبيرة يقال لها تامسنا، مثيرة الزرع والمرعى، وفيها مدن كثيرة.ومنها لمطة بفتح اللام وسكون الميم وفتح الطاء المهملة.وهي مدينة من الغرب الأقصى واقعةٌ في آخر الإقليم الثاني قال بعضهم: حيث الطول سبع درج وثلاثون دقيقة، والعرض سبعٌ وعشرون دقيقة، على ثلاث مراحل من البحر المحيط، ولها نهر كبير ينزل من جبلٍ في شرقيها على مرحلتين منها، يجري على جنوبيها غرباً بميلة إلى الشمال حتى يصب في البحر المحيط.ومنها السوس بضم السين المهملة وسكون الواو ثم سين ثانيةٍ.وهي مدينة أقصى المغرب في الإقليم الثاني.قال ابن سعيد: حيث الطول ثمان درج والعرض ست وعشرون درجة وعشرون دقيقة، وهي على طرف من البر داخلٍ في البحر أربعين ميلاً، وفي جانهبا الشمالي نهر يأتي من الشرق من جبل لمطة.ومنها قصر عبد الكريم وضبطه معروف.وهي مدينة من الغرب الأقصى في أوائل الإقليم الرابع.قال ابن سعيد: حيث الطول ثمان درج وثلاثون دقيقة، والعرض أربع وثلاثون درجة وأربعون دقيقة.وهي مدينة على نهر من جهتها الشمالية، وهو نهر كبير تصعد فيه المراكب من البحر المحيط، وجانباه محفوفان بالبساتين والكروم.وكان قاعدة تلك الناحية قبلها مدينةً اسمها البصرة يسكنها الأدراسة، فلما عمرت هذه المدينة صارت هي القاعدة.ومنها طنجة بفتح الطاء المهملة وسكون النون وفتح الجيم ثم هاء في الآخر.وهي مدينةٌ من أقاصي المغرب واقعةٌ في الإقليم الرابع.قال ابن سعيد: حيث الطول ثمان درج وإحدى وثلاثون دقيقة، والعرض خمسٌ وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة.وهي مدينة على بحر الزقاق، واتساع البحر عندها ثلث مجرىً، فإذا شرق عنها اتسع عن ذلك.وهي مدينة أزلية، واستحدث أهلها لهم مدينةً على ميل منها على ظهر جبل ليمتنعوا بها، والماء ينساق إليها في قني.قال في مسالك الأبصار: وكانت دار ملكٍ قديم.وهي التي كانت قاعدة تلك الجهات قبل الإسلام الى حين فتح الأندلس؛ وهي محط السفن؛ وهي كثيرة الفواكه، لا سيما العنب والكمثرى، وأهلها مشهورون بقلة العقل وضعف الرأي، على أن منها أبو الحسن الصنهاجي الطنجي، ترجم له في قلائد العيقان وأثنى عليه، وأنشد له أبياتاً منها: وافر. وكذلك أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الحضرمي القائل: [طويل] ومنها درعة بفتح الدال وسكون الراء وفتح العين المهملات وهاء في الآخر.وهي مدينة من حنوبي المغرب الأقصى واقعةٌ في الإقليم الثاني.نقل في تقويم البلدان: عن بعضهم أن طولها إحدى عشرة درجة وست دقائق، وعرضها خمسٌ وعشرون درجة وعشر دقائق.قال في نزهة المشتاق: وهي قرى متصلة، وعماراتٌ متقاربة، وليست بمدينة يحوط بها سور ولا حفير.ولها نهر مشهور في غربيها ينزل من ربوة حمراء عند جبل درن، وتنبت عليه الحناء، ويغوص ما يفضل منه بعد السقي في صحارى تلك البلاد.ومنها أغمات قال في اللباب: بفتح الألف وسكون الغين المعجمة وفتح الميم وألف وتاء مثناة من فوق في آخرها.وهي مدينةٌ من الغرب الأقصى، واقعةٌ في الإقليم الثالث.قال في تقويم البلدان: والقياس أن طولها إحدى عشرة درجةً وثلاثون دقيقة، والعرض ثمانٌ وعشرون درجة وخمسون دقيقة.وهي مدينةٌ قديمةٌ في الجنوب بميلة إلى الشرق إلى الرق عن مراكش، في مكان أفيح طيب التربة، كثير النبات والعشب، والمياه تخترقه يميناً وشمالأ.قال ابن سعيد: وهي التي كانت قاعدة ملك أمير المسليمن يوسف بن تاشفين قبل بناء مراكش.قال الأدريسي: وحولها جنات محدقة، وبساتين وأشجار ملتفة؛ وهواؤها صحيح، وفيها نهرٌ ليس بالكبير، يشق المدينة يأتيها من جنوبيها ويخرج من شماليها. وربما جمد في الشتاء حتى يجتاز عليه الأطفال.ومنها تادلا قال في تقويم البلدان عن الشيخ عبد الواحد: بفتح المثناة من فوق ثم ألف ودال مهملة مكسورة ولام ألف.ثم قال: وفي خط ابن سعيد تادلة في آخرها هاء، وهي مدينة بالمغرب الأقصى في جهة الجنوب في الإقليم الثالث.قال ابن سعيد: حيث الطول اثنتا عشرة درجة، والعرض ثلاثون درجة.قال ابن سعيد: وهي مدينة بين جبال صهناجة، ويقال هي قاعدة صهناجة، وغربيها جبل درن ممتد إلى البحر المحيط، وهي بين مراكش وبين أعمال فاس، ولها عمل جليل، وأهلها بربر يعرفون بحراوة.ومنها أزمور قال الشيخ شعيب: بفتح الهمزة والزاي المعجمة وتشديد الميم ثم واو وراء مهملة في الآخر.وهي مدينة على ميلين من البحر أكثر سكانها صهناجة.ومنها المزمة وهي فرضة ببر العدوة تقابل فرضة المنكب من بر الأندلس من ساحل غرناطة. والمزمة في الشرق عن سبتة بينهما مائتا ميل.ومنها مدينة باديس وهي فرضة مشهورة من فرض غمارة في الجنوب والشرق عن سبتة بينهما نحو مائة ميل.قال في تقويم البلدان: وهي قياساً حيث الطول عشر درج وثلاثون دقيقة، والعرض أربع وثلاثون درجة وخمسٌ وعشرون دقيقة.ومنها أودغست قال الشيخ عبد الواحد: بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الدال المهملة والغين المعجمة وسكون السين المهملة وفي آخرها تاء مثناة فوق.وهي مدينة في المغرب الأقصى في الجنوب في الصحراء في الإقليم الثاني.قال في الأطوال: حيث الطول ثمان درج وثمان دقائق.قال في القانون: والعرض ستٌ وعشرون درجة. قال: وهي في براري سودان المغرب.قال في العزيزي: وهي جنوبي سلجماسة وبينهما ستٌ وأربعون مرحلة في رمالٍ ومفاوز على مياه معروفة، ولها أسواقٌ جليلة، والسفن تصل إليها في البحر المحيط من كل بلد، وسكان هذه المدينة أخلاط من البربر المسلمين، والرياسة فيها لصناجة.قال في العزيزي: ولأودغست أعمالٌ واسعة، وهي شديدة الحرارة، وأمطارها في الصيف، ويزرعون عليها الحنطة، والذرة والدخن، واللوبيا، والكرسنة، وبها النخل الكثير وليس فيها فاكهة سوى التين، وبها شجر الحجاز كله: من السنط والمقل وغيرهما.قلت: وقد ذكر في مسالك الأبصار: عدة مدن غير هذه غير مشهورة يطول ذكرها.الجملة الثالثة في ذكر جبالها المشهورة:وهي عدة جبال منها جبل درنٍ بفتح الدال والراء المهملتين ونون في الآخر.قال ابن سعيد: وهو جبل شاهقٌ مشهور لا يزال عليه الثلج، أوله عند البحر المحيط الغربي في أقصى المغرب، وآخره من جهة الشرق على ثلاث مراحل من إسكندرية من الديار المصرية، ويسمى طرفه الشرقي المذكور رأس أوثانٍ، فيكون امتداده نحو خمسين درجة، وفي غربيه بلاد تينملك من قبائل البربر، وشرقيها بلاد هنتاتة من البربر أيضاً وشرقيها بلاد مشكورة منهم، وشرقيها بلاد المصامدة.ومنها جبل كزولة، وهي قبيلة من البربر. قال ابن سعيد: وابتداؤه من البحر المحيط الغربي، ويمتد مشرّقاً إلى حيث الطول اثنتا عشرة درجة، وموقعه بين الإقليم الثاني والإقليم الثالث، وبه مدينة اسمها تاعجست.ومنها جبل غمارة. بضم الغين المعجمة وفتح الراء بعد الألف. وهي قبيلةٌ من البربر أيضاً؛ وهو جبلٌ ببرّ العدوة فيه من الأمم ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وهو ركن على البحر الروميّ، فإن بحر الزقاق إذا جاوز سبتة إلى الشرق انعطف جنوباً إلى جبل عمارة المذكورة، وهناك مدينة باديس المقدم ذكرها.ومنها جبل مديونة. بفتح الميم وسكون الدال المهملة وضم المثناة من تحت وواو ثم نون مفتوحة وهاء في الآخر: وهو جبل ببرّ العدوة شرقي مدينة فاس، يمتد إلى الجنوب حتى يتصل بجبال درن، ومديونة قبيلةٌ من البربر واطنون به.ومنها جبال مدغرة وهي شرقي مديونة، ومعظم أهلها كومية- بضم الكاف وكسر الميم وفتح المثناة تحت وهاء في الآخر. وهي قبيلة من البربر، منها عبد المؤمن أحد أصحاب المهدي بن تومرت.ومنها جبل يسر بضم الياء المثناة تحت وسكون السين المهملة. وهو جبل شرقي مديونة أيضاً منه ينبع نهر يسر المذكور.ومنها جبل ونشريش وهو جبل يتصل بجبل يسر من شرقيه، وفيه تعمل البسط الفائقة، ومنه ينبع نهر سلف المشهور. قال ابن سعيد: وهو نهرٌ كبير يزيد عند نقص الأنهار كنيل مصر.الجملة الرابعة في ذكر أنهارها المشهورة:وهي عدة أنهار، منها نهر السوس الأقصى وهو نهر يأتي من الجنوب والشرق من جبلٍ يعرف بجبل لمطة، ويجري إلى الشمال، ويمر على مدينة السوس من شماليها، ويزرع على جانبيه قصب السكر والحناء وغير ذلك كما يزرع في مصر، ويجري حتى يصب في البحر المحيط الغربي.ومنها نهر سجلماسة الأتي ذكرها، وهو نهر منبعه من جنوبي سجلماسة بمسافةٍ بعيدةٍ، ويمر من شرقيها ويجري حتى يصب في نهر ملوية الأتي ذكره.ومنها نهر ملوية قال ابن سعيد: وهو نهرٌ كبيرٌ مشهورٌ في الغرب الأقصى، يصب إليه نهر سجلماسة ويصيران نهراً واحداً، يجري حتى يصب في بحر الروم شرقي سبتة.ومنها نهر فاس وهو نهر متوسط يشق مدينة فاسٍ كما تقدم قال في تقويم البلدان ومخرجه على نصف يومٍ من فاس، يجري في مروجٍ وأزاهر حتى يدخلها.المقصد الثاني في ذكر زروعها وحبوبها وفواكهها وبقولها ورياحينها ومواشيها ومعاملاتها وصفات أهلها:فيه خمس جمل:الجملة الأولى في ذكر زروعها وحبوبها وفواكهها وبقولها ورياحينها:أما زرعها فعلى المطر كما تقدم في أفريقية.وأما حبوبها: ففيها من أنواع الحبوب: القمح، والشعير، والفول، والحمص، والعدس، والدخن، والسلت وغير ذلك. أما الأرز فإنه عندهم قليل، بعضه يزرع في بعض الأماكن من بر العدوة وأكثره مجلوب إليهم من بلاد الفرنج. على أنهم لا نهمة لهم في أكله ولا عناية به. وبها السمسم على قلة، ولا يعتصر منه بالمغرب شيرج لاستغنائهم عنه بالزيت حتى مزورات الضعفاء وكذلك يعملون الحلوى بالعسل والزيت، وإنما يستعمل الشيرج عندهم في الأمور الطبية.وأما فواكهها، فيها أنواع الفواكه المستطابة اللذيذة المختلفة الأنواع: بين النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والسفرجل، والتفاح على أصناف، وكذلك الكمثرى، وتسمى عندهم الأنجاص كما بدمشق، وبها المشمش والتين، والبرقوق، والقراصيا، والخوخ، وغالب ذلك على عدة أنواع، والتوت على قلة، والجوز، واللوز. ولا يوجد بها الفستق والبندق إلا مجلوباً. وبها الأترج، والليمون، والليم، والنارنج، والزنبوع، وهو المسمى بمصر والشام الكباد. وبها البطيخ الأصفر والأخضر واسمه عندهم الدلاع كما في سائر بلاد المغرب على قلة، والموجود منه غير مستطاب. وبها الخيار، والقثاء، واللفت، والباذنجان، والقرع، والجزر، واللوبيا، والكرنب، والشمار، والصعتر وسائر البقول. والموز موجود بها في بعض المواضع نادراً، والقلقاس لا يزرع عندهم إلا للتفرج على عروقه لا لأن يؤكل، وبها قصب السكر بجزائر بني مزغنان وبسلا كثير، ويعصر ثم يعمل منه القند ومن القند السكر على أنواع لاسيما بمراكش، فإنه يقال إن بها أربعين معصرة للسكر، وإن حمل حمار من القصب يساوي درهماً من دراهمهم: وهو ثلث درهم من الدراهم المصرية؛ ويعمل منه المكرر الفائق، ومع ذلك فليس لهم به اهتمام لاكتفائهم عنه بعسل النحل مع كثرته عندهم، وميلهم إليه أكثر من السكر، حتى يقال إنه لا يستعمل السكر عندهم إلا الغرباء أو المرضى.وأما رياحينها، فبها الورد، والبنفسج، والياسمين، والأس، والنرجس، والسوسن، والبهار، وغير ذلك.الجملة الثانية في مواشيها ووحوشها وطيورها:أما مواشيها، ففيها من الدواب الخيل، والبغال، والحمير، والأبل، والبقر، والغنم؛ أما الجاموس فلا يوجد عندهم.وأما الطير، فبها منه الأوز، والحمام، والدجاج ونحوها، والكركي عندهم كثير على بعد الدار، واسمه عندهم الغرنوق، وهو صيد الملوك هناك كما بمصر والشام.وأما وحوشها، ففيها من أنواع الوحش الحمر، والبقر، والنعام، والغزال، والمها وغير ذلك.الجملة الثالثة فيما تتعامل به من الدنانير والدراهم والأوزان والمكاييل:أما مثاقيل الذهب فأوزانها لا تختلف، وأما الدراهم فذكر في مسالك الأبصار عن السلايحي: أن معاملتها درهمان: درهم كبير، ودرهم صغير؛ فالدرهم الكبير قدر ثلث درهمٍ من الدراهم النقرة بمصر والشام، والدرهم الصغير على النصف من الدرهم الكبير يكون قدر سدس درهم نقرة بمصر والشام. وعند الأطلاق يراد الدرهم الصغير دون الدرهم الكبير إلا بمراكش وما جاورها، فإنه يراد بالدرهم عند الأطلاق الدرهم الكبير. قال: وكل مثقال ذهب عندهم يساوي ستين درهماً كباراً، تكون بعشرين درهماً من دراهم النقرة بمصر.وأما رطلها فعلى ما تقدم من رطل أفريقية، وهي كل رطل ست عشرة أوقية، كل أوقية أحدٌ وعشرون درهماً من دراهمها.وأما كيلها فأكثره الوسق ويسمى الصفحة وهو ستون صاعاً بالصاع النبوي على السواء.الجملة الرابعة في ذكر أسعارها:قد ذكر في مسالك الأبصار عن السلايحي أيضاً عن سعر زمانه المتوسط في غالب الأوقات، وهي الدولة الناصرية محمد بن قلاوون وما قاربها: أن سعر كل وسقٍ من القمح أربعون درهماً من الدراهم الصغار: وهو ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم من نقرة مصر، والشعير دون ذلك. وكل رطل لحمٍ بدرهمٍ واحدٍ من الدراهم الصغار، وكل طائر من الدجاج بثلاثة دراهم من الصغار، وعلى نحو ذلك.الجملة الخامسة في صفات أهلها في الجملة:قد تقدم أن معظم هذه المملكة في الإقليم الثالث. قال ابن سعيد: والإقليم الثالث هو صاحب سفك الدماء، والحسد، والحقد، والغل، وما يتبع ذلك. ثم قال: وأنا أقول: إن الإقليم الثالث وإن كثرت فيه الأحكام المريخية على زعمهم، فإن للمغرب الأقصى من ذلك الحظ الوافر، لا سيما في جهة السوس وجبال درن، فإن قتل الأنسان عندهم كذبح العصفور، قال وكم قتيل قتل عندهم على كلمةٍ وهم بالقتل يفتخرون. ثم قال: إن الغالب على أهل المغرب الأقصى كثرة التنافس المفرط، والمحاققة، وقلة التغاضي، والتهور، والمفاتنة.أما البخل فإنما هو في أراذلهم، بخلاف الأغنياء، فإن في كثير منهم السماحة المفرطة والمفاخرة بإطعام الطعام والأعتناء بالمفضول والفاضل.المقصد الثالث في ذكر ملوكها وما يندرج تحت ذلك من انتقال الملك من الموحدين إلى بني مرينٍ والتعريف بالسلطان أبي الحسن الذي أشار إليه في كلامه في التعريف:وهم على طبقات:الطبقة الأولى: ملوكها قبل الإسلام:قد تقدم أن بلاد المغرب كلها كانت مع البربر، ثم غلبهم الروم الكيتم عليها ثم افتتحوا قرطاجنة وملوكها، ووقع بين البربر والروم فتن كثيرة كان آخرها أن وقع الصلح بينهم على أن تكون البلاد والمدن الساحلية للروم، والجبال والصحارى للبربر، ثم زاحم الفرنج الروم في البلاد، وجاء الإسلام والمستولي عليها من ملوك الفرنجة جرجيس ملكهم، وكان ملكه متصلا من طرابلس إلى البحر المحيط، وكرسي ملكه بمدينة سبيطلة، ومن يده انتزعها المسلمون عند الفتح.الطبقة الثانية: نواب الخلفاء من بني أمية وبني العباس:كان كرسي المملكة بعد الفتح بأفريقية، وكان نواب الخلفاء يقيمون بها وينزلون القيروان، وكانوا يولون على ما فتح من بلاد المغرب من تحت أيديهم. فبقي الأمر على ذلك أيام عبد الله بن أبي سرح، الذي افتتحها في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم أيام معاوية بن صالح، ثم أيام عقبة بن نافع، ثم أيام أبي المهاجر، ثم أيام عقبة بن نافع ثانياً، ثم أيام زهير بن قيس، ثم أيام حسان بن النعمان ثم أيام موسى بن نصير، ثم أيام محمد بن يزيد، ثم أيام إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر، ثم أيام يزيد بن أبي مسلم، ثم أيام بشر بن صفوان الكلبي، ثم أيام عبيد بن عبد الرحمن السلمي، ثم أيام عبد الله بن الحبحاب، ثم أيام كلثوم بن عياض، ثم أيام حنظلة بن صفوان، ثم أيام عبد الرحمن بن حبيب، ثم أيام حبيب بن عبد الرحمن، ثم أيام عبد الملك بن أبي الجعد، ثم أيام عبد الأعلى بن السمح المعافري، ثم أيام محمد بن الأشعث، ثم أيام الأغلب بن سالم، ثم أيام عمرو بن حفص، ثم أيام يزيد بن حاتم بن قبيصة، ثم أيام روح بن حاتم، ثم أيام الفضل بن روح، ثم أيام هرثمة بن أعين، ثم أيام محمد بن مقاتل، ثم أيام إبراهيم بن الأغلب، ممن تقدم ذكره في ملوك أفريقية في خلافة هارون الرشيد. وفي أيامه ظهرت دعوة الأدارسة الأتي ذكرهم بعد هذه الطبقة. وسيأتي بسط القول فيهم بعض البسط في الكلام على مكاتبة صاحب تونس.الطبقة الثالثة: الأدارسة:بنو إدريس الأكبر بن حسن المثلث، بن حسن المثنى، بن الحسن السبط، بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وكان مبدأ أمرهم أنه لما خرج حسين بن علي بن حسنٍ المثلث بمكة سنة سبعين ومائة أيام الهادي واجتمع عليه قرابته وفيهم عمه إدريس وقتل الحسين، فر إدريس ولحق بالمغرب، وصار إلى مدينة وليلي من المغرب الأقصى، فاجتمع إليه قبائل البربر وبايعوه وفتح أكثر البلاد، وبقي حتى مات سنة خمس وسبعين ومائة. وأقاموا الدعوة بعده لابنه إدريس الأصغر.وكان أبوه قد مات وترك أمه حاملاً به فكفلوه حتى شب، فبايعوه سنة ثمانٍ وثمانين ومائة، وهو ابن إحدى عشرة سنةً، وافتتح جميع بلاد المغرب وكثر عسكره، وضاقت عليهم وليلي فاختط لهم مدينة فاس سنة ثنتين وتسعين ومائة على ما تقدم وانتقل إليها، واستقام له الأمر واستولى على أكثر بلاد البربر، واقتطع دعوة العباسيين، ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين.وقام بالأمر بعده ابنه محمد بن إدريس ومات سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد أن استخلف في مرضه ولده عليشا بن محمد وهو ابن تسع سنين، ومات سنة أربع وثلاثين ومائتين لثلاث عشرة سنةً من ولايته.وكان قد عهد لأخيه يحيى بن محمد فقام بالأمر بعده ومات.فولي مكانه ابنه يحيى بن يحيى ثم مات فاستدعوا ابن عمه علي بن عمر ابن إدريس الأصغر فبايعوه بفاس، واستولى على جميع أعمال المغرب، وقتل سنة اثنتين وتسعين ومائتين.وقام بالأمر بعده يحيى بن إدريس بن عمر، بن إدريس الأصغر، وملك جميع المغرب وخطب له على منابره، وبقي حتى وافته جيوش عبيد الله المهدي الفاطمي، فغلبوه على ملكه وخلع نفسه من الأمر وأنفذ بيعته إلى المهدي سنة خمس وثلثمائة واستقر عاملاً للمهدي على فاس وعملها خاصةً، وبقية المغرب بيد موسى بن أبي العافية كما سيأتي.الطبقة الرابعة: ملوك بني أبي العافية من مكناسة:كانت مكناسة من قبائل البربر لأول الفتح بنواحي تارا من أوساط المغرب الأقصى والأوسط وكانوا يرجعون في رياستهم إلى بني أبي باسل بن أبي الضحاك وكانت الرياسة في المائة الثالثة لمصالة- بن حيوس، بن منازل، بن أبي الضحاك، بن يزول، بن تافرسين، بن فراديس، بن ونيف، بن مكناس، بن ورصطف، بن يحيى، بن تمصيت، بن ضريس، بن رجيك، بن مادغش، بن بربر-؛ وموسى بن أبي العافية، بن أبي باسل، بن أبي الضحاك المتقدم ذكره.ولما استولى عبيد الله المهدي على المغرب صار مصالة بن حيوس من أكبر قواده وولاه مدينة تاهرت والغرب الأوسط.ولما زحف مصالة إلى المغرب الأقصى سنة خمس وثلثمائة واستولى على فاس ثم على سجلماسة واستنزل يحيى بن إدريس بفاس إلى طاعة عبيد الله المهدي وأبقاه أميراً على فاس على ما تقدم، عقد لابن عمه موسى بن أبي العافية أمير مكناسة على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل: تسول وتازا وما معهما وقفل مصالة إلى القيروان.فقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب، وعاود مصالة غزو المغرب سنة تسع وثلثمائة: أغراه موسى بن أبي العافية بيحيى بن إدريس، فقبض عليه وأخذ ماله وطرده، فلحق ببني عمه بالبصرة والريف، وولى مصالة مكانه على فاس ريحاناً الكتامي وقفل إلى القيروان فمات، وعظم ملك موسى بن أبي العافية بالمغرب.ثم ثار بفاس سنة ثلاث عشرة وثلثمائة الحسن بن محمد بن القاسم، بن إدريس الملقب بالحجام، ودخل فاس على حين غفلة من أهلها وقتل ريحاناً واليها، واجتمع الناس على بيعته، ثم خرج لقتال ابن أبي العافية والتقوا، فهلك جماعةٌ من مكناسة ثم كانت الغلبة لهم. ورجع الحسن مهزوماً إلى فاس فغدر به عامله على عدوة القرويين: حامد بن حمدان الهمداني، فقبض عليه واعتقله وأمكن ابن أبي العافية من البلد، وزحف إلى عدوة الأندلسيين فملكها وقتل عاملها، وولى مكانه أخاه محمداً، واستولى ابن أبي العافية على فاس وجميع المغرب وأجلى الأدارسة عنه.ثم استخلف على المغرب الأقصى ابنه مدين وأنزله بعدوة القرويين، واستعمل على عدوة الأندلسيين طوال بن أبي زيد، وعزل عنه محمد بن ثعلبة. ونهض إلى تلمسان سنة تسع عشرة وثلثمائة فملكها، وغلب عليها صاحبها الحسن بن أبي العيش بن عيسى، بن إدريس، بن محمد بن سليمان: من عقب سليمان ابن عبد الله: أخي إدريس الأكبر الداخل إلى المغرب بعده؛ ورجع بعد فتحها إلى فاس وخرج عن طاعة العبيديين، وخطب للناصر الأموي خليفة الأندلس على منابر عمله، فبعث عبيد الله المهدي قائده حميداً المكناسي ابن أخي مصالة إلى فاس، ففر عنها مدين بن موسى بن أبي العافية إلى أبيه فدخلها حميد، ثم استعمل عليها حامد بن حمدان ورجع إلى أفريقية، وقد دوخ المغرب.ثم انتقض أهل المغرب على العبيديين بعد مهلك عبيد الله، وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل الجذامي على حامد بن حمدان عامل فاس فقتله وبعث برأسه إلى موسى بن أبي العافية، فبعث به إلى الناصر الأموي بالأندلس واستولى على المغرب، وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم بن عبيد الله المهدي سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة إلى فاس وحاصرها فأحجم ابن أبي العافية عن لقائه، واستنزل ميسورٌ أحمد بن بكر عاملها وقبض عليه وبعث به إلى المهدية.ثم خرج أهل فاس عن طاعته، وقدموا على أنفسهم حسن بن قاسمٍ اللواتي، ثم حاصرهم ميسورٌ فدخلوا تحت طاعته، واشترطوا على أنفسهم الأتاوة، فقبل ميسورٌ ذلك منهم، وأقر حسن بن قاسم على ولايته بفاس، وارتحل إلى حرب بن أبي العافية، فكانت بينهم حروب آخرها أن ظهر ميسور على ابن أبي العافية، وأجلاه عن أعمال المغرب إلى بلاد الصحراء، ثم قفل ميسورٌ إلى القيروان سنة أربع وعشرين وثلثمائة. ورجع موسى بن أبي العافية من الصحراء إلى أعماله بالمغرب، وزحف إلى تلمسان، ففر عنها أبو العيش ولحق بتكور، واستفحل أمر ابن أبي العافية بالمغرب الأقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك مغراوة وصاحب المغرب الأوسط، وبثوا دعوة الأموية في أعمالها، وبعث ابنه مدين إلى منازلة فاس فحاصرها، وهلك موسى في خلال ذلك سنة سبع وعشرين وثلثمائة.وقام ابنه مدين بأمره، وعقد له الناصر الأموي على أعمال أبيه بالمغرب، ثم قسم أعماله بينه وبين أخويه البوري وأبي منقذ، وأجاز البوري إلى الناصر بالأندلس سنة خمس وثلاثين وثلثمائة فعقد له ثم هلك سنة خمس وأربعين وثلثمائة وهو محاصرٌ لأخيه مدين بفاس، فعقد الناصر لابنه منصور على عمله.ثم توفي مدين، فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله؛ ثم غلب مغراوة على فاس وأعمالها، واستفحل أمرهم بالمغرب. وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه وأعماله؛ وأجاز إسماعيل بن البوري ومحمد بن عبد الله بن مدين إلى الأندلس، فنزلا بها إلى أن أجازوا مع واضح أيام المنصور بن أبي عامر عندما خرج زيري بن عطية عن طاعتهم سنة ستٍّ وثمانين وثلثمائة.الطبقة الخامسة: بنو زيري بن عطية من مغراوة من البربر:وهو زيري بن عطية، بن عبد الله، بن خزر، بن محمد، بن خزر، بن حفص، بن صولات، بن رومان، من بطون زناتة من البربر، وكان أولية أمره أن زيري هذا كان أمير بني خزر في وقته، وانتهت إليه رياستهم وإمارتهم في البداوة. ولما غلب بلكين بن زيري الصنهاجي صاحب أفريقية وقومه صنهاجة على المغرب الأوسط سنة تسع وستين وثلثمائة وأجلوا عنه مغراوة الذين كانوا به من تقادم السنين وصار المغرب الأوسط جميعه لصنهاجة، لحق مغراوة فيمن بقي من بني خزر، بالغرب الأقصى؛ وأمراؤهم يومئذ محمد بن الخير، ومقاتلٌ وزيري ابنا عطية بن عبد الله، وخزرون بن فلفول، ووصلوا إلى سبتة وأميرهم المنصور بن أبي عامر حاجب.وبعث العزيز بن نزار العبيدي من مصر الحسن بن كنون من الأدارسة لاسترجاع ملكه بالمغرب، فبعث المنصور لحربه أبا الحكم عمرو بن عبد الله بن أبي عامر الملقب بعسكلاجة سنة خمس وسبعين وثلثمائة، وانحاش إليه زيري ابن عطية ومن معه من بني خزر في جموع مغراوة، وزحفوا إلى الحسن بن كنون حتى ألجأوه إلى الطاعة، ثم انصرف أبو الحكم بن أبي عامر إلى الأندلس، فعقد المنصور بن أبي عامر على المغرب الأقصى للوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي، وأنفذه إليه سنة ست وسبعين وثلثمائة، وأوصاه بملوك مغراوة خصوصاً زيري؛ فسار الحسن بن أحمد حتى نزل بفاس وضبط أعمال المغرب، ومات مقاتل بن عطية سنة ثمان وسبعين وثلثمائة واستقل أخوه زيري بن عطية برياسة مغراوة؛ وبقي الحسن بن أحمد إلى أن قتل في بعض الحروب سنة إحدى وثمانين وثلثمائة، وبلغ الخبر المنصور بن أبي عامر فعقد على المغرب لزيري ابن عطية المذكور، وكتب إليه بعهده وأمره بضبط المغرب، فاستفحل ملكه وغلب على تلمسان. فملكها من يد أبي البهار الصنهاجي، وبعث بالفتح إلى المنصور بن أبي عامر فجدد له العهد، واختط مدينة وجدة سنة أربع وثمانين، وأنزل بها عساكره.ثم فسد ما بين المنصور بن أبي عامر وبين زيزي بن عطية، فعقد المنصور لمولاه واضحٍ على المغرب، وعلى حزب زيزي بن عطية، وجهزه إليه في عساكره؛ ثم أتبعه المنصور ابنه المظفر عبد الملك فاجتمعا على زيزي بن عطية، ودارت بينهم الحرب فكانت الهزيمة على زيزي وجرح في المعركة وفر إلى فاس فامتنع عليه أهلها، فلحق بالصحراء جريحاً؛ وكتب عبد الملك بن المنصور بالفتح إلى أبيه فاستبشر به وكتب إلى ابنه عبد الملك بعهده على المغرب.وكان زيزي بن عطية لما فر إلى الصحراء صرف وجهه إلى حرب صهناجة بالمغرب الأوسط فقصده وفتح تاهرت وتلمسان وأعمالهما، وأقام الدعوة فيها لهشام بن عبد الملك خليفة الأندلس وحاجبه المنصور من بعده، وبقي على ذلك حتى مات سنة إحدى وتسعين وثلثمائة.وبويع من بعده ابنه المعز ين زيزي فجرى على سنن أبيه من الدعاء لهشام بن عبد الملك والمنصور من بعده؛ ومات المنصور في خلال ذلك.وقام بأمره من بعده ابنه المظفر عبد الملك وبعث المعز بن زيزي يرغب إلى المظفر في عمل فاس والمغرب الأقصى فأجابه إلى ذلك، وكتب له عهده بذلك، خلا سجلماسة فإنها كانت بيد خزرون، وبقي المعز في ولايته إلى أن هلك سنة سبع عشرة وأربعمائة.وولي من بعده ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية واستفحل ملكه؛ ثم نازعه الأمير أبو الكمال تميم بن زيزي بن يعلى اليفرني سنة أربع وعشرين وأربعمائة، واستقل بملك المغرب وبقي حتى مات سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.وولي من بعده ابنه دوناس المعروف بأبي العطاف، واستولى على فاس وسائر عمل أبيه، فاستقامت دولته، واحتفل بعمارة فاس وأدار السور على أرباضها، وبنى بها المصانع، والحمامات، والفنادق، وبقي حتى مات سنة إحدى وخمسين وأربعمائة.وولي من بعده ابنه الفتوح بن دوناس ونازعه أخوه الأصغر عجيسة واستولى على عدوة القرويين من فاس، وبقي الفتوح بعدوة الأندلسيين، وافترق أمرههما ووقعت الحرب بينهما؛ وابتنى الفتوح بعدوة الأندلسيين باب الفتوح المعروف به إلى الآن، وابتنى عجيسة بعدوة القرويين باب الجيسة المعروف به إلى الآن، وحذفت العين منه لكثرة دورانه على الألسنة، وبقي الأمر على ذلك حتى ظفر الفتوح بأخيه عجيسة، وقتله سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، ودهم المغرب على إثر ذلك ما دهمه من أمر المرابطين من لمتونة، وخشي الفتوح عاقبة أمرهم، فرحل على فاس وتركها.وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن حماد إلى المغرب سنة أربع وخمسين، فدخل فاس واسترهن بعض أشرافهم على الطاعة ورجع إلى عمله، وولي على المغرب بعد الفتوح معتصر بن حماد ن بن معتصر، بن المعز، بن زيزي.وزحف يوسف بن تاشفين إلى فاس فملكها صلحاً سنة خمسٍ وخمسين وأربعمائة وخلف عليها عامله، وارتحل إلى غمازة فخالفه معتصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من لمتونة، وبلغ الخبر يوسف بن تاشفين فأرسل العساكر إلى فاس وحاصرها، وخرج معتصر للقاء عساكره، فكانت الدائرة عليه وقتل في المعركة سنة ستين وأربعمائة.وبايع أهل فاس من بعده ابنه تميم بن معتصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنةٍ وشدة وغلاء.ولما فرغ يوسف بن تاشفين من أمر عمارة سنة ثنتين وستين وأربعمائة قصد فاس فحاصرها أياماً ثم افتتحها عنوة وقتل بها نحو ثلاثة الأف من مغراوة وبني يفرن ومكناسة وقبائل زناتة وهلك تميم بن معتصر في جملتهم، وأمر يوسف بن تاشفين بهدم الأسوار التي كانت فاصلةً بين العدوتين وصيرهما مصراً واحداً وأدار عليهما سوراً واحداً، وفر من خلص من القتل من مغراوة من فاس إلى تلمسان، وانقرض ملكهم من الغرب الأقصى وتصاريف الأمور بيد الله تعالى.الطبقة السادسة: المرابطون من الملثمين من البربر:كان الملثمون من البربر من صهناجة قبل الفتح الإسلامي متوطنين في القفار وراء رمال الصحراء: ما بي بلاد البربر وبلاد السودان، في جملة قبائل صهناجة على دين المجوسية؛ قد اتخذوا اللثام شعاراً يميز بينهم وبين غيرهم من الأمم؛ والرياسة فيهم يومئذ للمتونة، ولم يزالوا على ذلك إلى أن كان فتح الأندلس واستمر ملكهم أيام عبد الرحمن أول خلفاء بني أمية بالأندلس.قال ابن أبي زرع: أول من ملك الصحراء من لمتونة يتلوثان وكان يركب في ألف نجيب وتوفي في سنة اثنتين وعشرين ومائتين.وملك بعده يلتان فقام بأمرهم وتوفي سنة سبع وثمانين ومائتين.وقام بأمرهم بعده ابنه تميمٌ إلى سنة ست وثلثمائة وقتله صهناجة.ثم افترق أمرهم بعد تميم مائةً وعشرين سنة إلى أن قام فيهم أبو عبد الله بن نيفاوت المعروف بتادشت اللمتوني، وحج ومات لثلاثة أعوام من رياسته عليهم.وقام بأمرهم صهره يحيى بن إبراهيم فحج في سني أربعين وأربعمائة، وعاد وصحبته عبد الله بن ياسين الجزولي ليعلمهم الدين، فلما مات يحيى بن إبراهيم اطرحوا عبد الله بن ياسين واستعصوا عليه وتركوا الأخذ بقوله فاعتزلهم، ثم اجتمع عليه رجال من لمتونة فخرج فيهم وقاتل من استعصى عليه منهم حتى أنأبوا إلى الحق وسماهم المرابطين، وجعل أمرهم في الحرب إلى الأمير يحيى بن عمر، بن واركوت، بن ورتنطق، بن المنصور، بن مرصالة، بن منصور، بن فرصالة، بن أميت، بن راتمال، بن تلميت، وهو لمتونة، فافتتحوا درعة وسجلماسة، واستعملوا عليها منهم، وعادوا إلى الصحراء، وهلك يحيى بن عمر سنة سبع وأربعين وأربعمائة.وولي مكانه أخوه أبو بكر بن عمر ثم افتتحوا بلاد السوس سنة ثمان وأربعين ثم مدينة أغمات سنة تسع وأربعين، ثم بلاد المصامدة وجبال درن سنة خمسين، ثم استشهد عبد الله بن ياسين في بعض الغزوات سنة خمسين، واستمر أبو بكر بن عمر في إمارة قومه، وافتتح مدينة لواته سنة ثنتين وخمسين، ثم ارتحل إلى الصحراء لجهاد السودان واستعمل على المغرب ابن عمه يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن واركوت، فسار يوسف في عسكره من المرابطين ودوخ أقطار المغرب، واختط مدينة مراكش سنة أربع وخمسين.ثم انتزع جبال زناته بالمغرب من أيديهم، ثم افتتح فاس صلحاً سنة خمس وخمسين ثم استعيدت بعد فتحها، ثم فتحها عنوةٌ سنة اثنتين وستين وأربعمائة، وأمر بهدم الأسوار التي كانت فاصلةً بين عدوتي القرويين والأندلسيين وصيرهما مصراً واحداً، ثم افتتح بعد ذلك مدينة تلمسان واستولى على الغرب الأقصى والغرب الأوسط، ثم صار إلى الأندلس واستولى على أكثر ممالكه كما سيأتي في ذكر مكاتبة صاحب الأندلس، ثم توفي يوسف بن تاشفين على رأس المائة الخامسة.وقام بالأمر بعده ابنه علي بن يوسف فاستولى على ما كان بيد أبيه من العدوتين، وسار فيهم بأحسن السيرة. ولأربع عشرة سنةً من ولايته كان ظهور المهدي بن تومرت صاحب دولة الموحدين. ومات علي بن يوسف سنة سبع وثلاثين، وقد ضعفت كلمة المرابطين بالأندلس لظهور الموحدين.وقام بالأمر بعده ولده تاشفين بن علي وأخذ بطاعته وبيعته أهل العدوتين، وقد استفحل أمر الموحدين وعظم شأنهم، ونزل تلمسان فقصده الموحدون، ففر إلى وهران واتبعه الموحدون، ففقد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، واستولى الموحدون على الغرب الأوسط.ثم بويع بمراكش إبراهيم بن تاشفين، بن علي، بن يوسف بن تاشفين، فألفوه عاجزاً فخلعوه.وولي مكانه عمه إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين، وقد ملك الموحدون جميع بلاد المغرب وقصدوه في مراكش، فخرج إليهم في خاصته فقتلوه، وأجاز عبد المؤمن والموحدون إلى الأندلس، فملكوه سنة إحدى وخمسين وخمسمائة، وفر أمراء المرابطين في كل وجه.الطبقة السابعة: ملوك الموحدين:كان أول أمرهم أن المهدي محمد بن تومرت، كان إماماً متضلعاً بالعلوم، قد حج ودخل العراق واجتمع بأئمته من العلماء والنظار، كالغزالي وإليكا الهراسي وغيرهما، وأخذ بمذهب الأشعرية أهل السنة، ورجع إلى الغرب وأهله يومئذٍ على مذهب أهل الظاهر في منع التأويل، فاجتمع إليه قبائل المصامدة من البربر وجعل يبث فيهم عقائد الأشعرية، وينهى عن الجمود على الظاهر، وسمي أتباعه الموحدين، تعريضاً بتكفير القائلين بالتجسيم الذي يؤدي إليه الوقوف على الظاهر.وكان الكهان يتحدثون بظهور دولةٍ بالمغرب لأمة من البربر، وصرفوا القول في ذلك إليه، ودعا المصامدة بيعته على التوحيد وقتال المجسمين سنة خمس عشرة وخمسمائة فبايعوه على ذلك.ولما كملت بيعته لقبوه المهدي، وكان قبل ذلك يلقب الأمام، وأخذوا في قتال المرابطين من لمتونة حتى استقاموا على الطاعة. وتوفي المهدي سنة ثنتين وعشرين وخمسمائة.وقام بالأمر بعده عبد المؤمن بن علي بعهده إليه. فكان من أمره ما تقدم من استيلائه على العدوتين وانقراض ملك المرابطين بهما، وكان ذلك من سنة أربع وثلاثين وخمسمائة إلى سنة إحدى وأربعين. ثم صرف همه إلى بجاية وأفريقية فافتتحهما، واستخلص المهدية والبلاد الساحلية التي كانت النصارى قد استولوا عليها من أيديهم واستولى على سائر بلاد أفريقية، وعاد إلى الغرب في سنة ست وخمسين وخمسمائة. وتوفي بسلا من الغرب الأقصى في جمادى الأخرة سنة ثمانٍ وخمسين.وبويع بعده ابنه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن فاستولى على ما كان بيد أبيه من العدوتين وأفريقية، واشتغل بإصلاح الممالك وجهاد العدو، وأجاز إلى الأندلس لجهاد النصارى، وقتل في بعض غزواته فيه بسهم أصابه. وقيل مرض فمات سنة ثمانين وخمسمائة.وبويع ابنه يعقوب بن يوسف بإشبيلية عقب وفاته وتلقب بالمنصور، فاستولى على ما كان بيد أبيه من الممالك إلى الأندلس، وكان له مع العدو وقائع، ومرض بالأندلس فمات سنة خمس وتسعين وخمسمائة.ويويع ابنه محمد ولي عهده وتلقب الناصر لدين الله، ورجع إلى بلاد المغرب. وفي أيامه ثار ابن غانية على أفريقية وتغلب عليها، وولى أبا محمد ابن الشيخ أبي حفص عليها، فاستقرت بها قدم بنيه إلى الآن، وأجاز إلى الأندلس ونزل إشبيلية، والتقى مع العدو في صفر سنة تسع وستمائة، وابتلي المسلمون في ذلك اليوم ورجع إلى مراكش فمات في شعبان من السنة المذكورة.وبويع ابنه يوسف بن محمد سنة إحدى عشرة وستمائة، وهو ابن ست عشرة سنةً، ولقب المستنصر بالله، وتأخر أبو محمد ابن الشيخ أبي حفص عن بيعته لصغر سنة، وغلب عليه مشيخة الموحدين فقاموا بأمره. وبقي الستنصر حتى مات يوم الأضحى سنة ست وعشرين وستمائة.وبويع بعده أبو محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن، وهو أخو المنصور ويعرف بالمخلوع. وكان الوالي بالمرسية من الأندلس أبو محمد عبد الله بن يعقوب بن المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن. فثار بالأندلس ودعا لنفسه وتلقب العادل. واتصل الخبر بمراكش فاضطرب الموحدون على المخلوع وبعثوا ببيعتهم إلى العادل بالأندلس، وبادر العادل إلى مراكش فدخلها وبقي حتى قتل بها أيام الفطر سنة أربع وعشرين وستمائة.وكان أخوه إدريس بن المنصور بإشبيلية من الأندلس فدعا لنفسه وبويع وبعث الموحدون ببيعتهم إليه، ثم قصد مراكش فهلك في طريقه بوادي أم الربيع مفتتح سنة ثلاثين وستمائة، وتغلب ابن هود على سبتة.وبويع بعده ابنه المأمون عبد الواحد بن إدريس فلقب الرشيد، ودخل إلى مراكش فبايعوه، وبقي حتى توفي سنة أربعين وستمائة.وبويع بعده أخوه أبو الحسن علي السعيد ولقب المعتضد بالله، وقام بالأمر ثم سار إلى تلمسان فكان بها مهلكه على يد بني عبد الواد في صفر سنة ست وأربعين وستمائة، وكان فيها استيلاء النصارى على إشبيلية.ثم اجتمع الموحدون على بيعة أبي حفص عمر بن أبي إسحاق بن يوسف، بن عبد المؤمن، فبايعوه ولقب المرتضى وكان بسلا فقدم إلى مراكش. وفي أيامه استولى أبو يحيى بن عبد الحق المريني جد السلطان أبي الحسن على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستمائة، واستبد العزفي بسبتة.ثم انتقض على المرتضى قائد حروبه أبو العلاء الملقب بأبي دبوس، بن أبي عبد الله محمد، بن أبي حفص، بن عبد المؤمن، ففر منه واجتمع عليه جموعٌ من الموحدين وقصد مراكش وبها المرتضى فغلبه عليها، والتقيا وفر المرتضى إلى أزمور فقبض عليه وإليها واعتقله إلى أن ورد أمر أبي دبوس بقتله فقتله، واستقل أبو دبوس بالأمر وتلقب الواثق بالله والمعتمد على الله.ثم جمع بعقوب بن عبد الحق وقصد مراكش فخرج إليه أبو دبوس، فكانت الهزيمة على أبي دبوس، ففر هارباً فأدرك وقتل، ودخل يعقوب بن عبد الحق مراكش وملكها سنة ثمانٍ وستين وستمائة، وفر مشيخة الموحدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد الواحد بن أبي دبوس ولقبوه المعتصم، فأقام خمسة أيام، وخرج في جملتهم، وانقرض أمر بني عبد المؤمن، ولم يبق للموحدين ملكٌ إلا بأفريقية لبني أبي حفص على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.الطبقة الثامنة: ملوك بني عبد الحق من بني مرين القائمون بها إلى الآن:وهو عبد الحق بن محيو، بن أبي بكر، بن حمامة، بن محمد، بن ورزيز، ابن فكوس، بن كوماط، بن مرين، بن ورتاجن، بن ماخوخ، بن جديح، بن فاتن، بن بدر، بن نجفت، بن عبد الله، بن ورتبيص، بن المعز، بن إبراهيم، بن رجيك، بن واشين، بن بصلتين، بن مشد، بن إكيا، بن ورسيك، بن أديدت، بن جانا، وهو زناتة.كانت منازل بني مرينٍ ما بين فيكيك إلى صا وملوية، وكانت الرياسة فيهم لمحمد بن ورزيز بن فكوس.ولما هلك محمد قام بأمره من بعده ابنه حمامة ثم من بعده أخوه عسكر ولما هلك قام برياسته ابنه المخضب فلم يزل أميراً عليهم إلى أن قتل في حرب الموحدين في سنة أربعين وخمسمائة.وقام بأمرهم من بعده أبو بكر ابن عمه حمامة بن محمد وبقي حتى هلك.فقام من بعده ابنه محيو ولم يزل حتى أصابته جراحةٌ في بعض الحروب، وهو في عداد المنصور بن عبد المؤمن، وهلك منها بعد مرجعه إلى الزاب سنة إحدى وتسعين وخمسمائة.وقام برياسته ابنته عبد الحق بن محيو وكان أكبر أولاده، وهو الذي تنسب إليه ملوك فاس الآن. فأحسن السير في إمارته إلى أن كانت أيام المستنصر يوسف ابن الناصر: خامس خلفاء بني عبد المؤمن فثارت بينه وبين بني مرين، وكانت بينهم حروب هلك في بعضها عبد الحق بن محيو.ونصب بنو مرينٍ بعده ابنه أبا سعيد عثمان بن عبد الحق وشهرته بينهم ادرغال، ومعناه بلغتهم الأعور، وقوي سلطانه وغلب على ضواحي المغرب، وضرب الأتاوة عليهم وتابعه أكثر القبائل، وفرض على أمصار المغرب مثل فاس وتازا وغيرهما ضريبةً معلومة في كل سنة على أن يكف الغارة عنهم. ولم يزل على ذلك إلى أن قتله علج من علوجه سنة سبع وثلاثين وستمائة.وقام بأمر بني مرين من بعده أخوه محمد بن عبد الحق فجرى على سنن أخيه في الأستيلاء على بلاد المغرب، وضرب الأتاوة على بلاده ومدنه إلى أن كانت أيام السعيد بن المأمون من بني عبد المؤمن، فجز عساكر الموحدين لقتال بني مرينٍ، فخرجوا إليهم في جيشٍ كثيفٍ في سنة ثنتين وأربعين وستمائة، ودارت الحرب بينهم فكانت الهزيمة على بني مرين، وقتل محمد بن عبد الحق.وقتام بأمره من بعده ابنه أبو يحيى زكريا بن عبد الحق وقسم جبايته ببلاد المغرب في عشائر بني مرين، ودارت الحرب ينهم وبين الموحدين، إلى أن مات السعيد بن المأمون من بني عبد المؤمن، وانتقل الأمر من بعده إلى ابنه عبد الله، فضعفت دولة بني عبد المؤمن. واستولى أبو يحيى بن عبد الحق على أكثر بلاد المغرب، وقصد فاس وبها بعض بني عبد المؤمن فأناخ عليها وتلطف بأهلها، ودعاهم إلى الدعوة الحفصية بأفريقية، فأجأبوه إلى ذلك وبايعوه خارج باب الفتوح. ودخل إلى قصبة فاس لشهرين من موت السعيد في أول سنة ست وأربعين وستمائة، وبايعه أهل تازا وأهل سلا ورباط الفتح، واستولى على نواحيها، وأقام فيها الدعوة الحفصية، واستبد بنو مرينٍ بملك المغرب الأقصى، وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط.وملك سجلماسة سنة ثلاثٍ وخمسين وستمائة من أيدي عامة الموحدين وبقي حتى هلك بفاس في رجبٍ سنة ست وخمسين وستمائة، ودفن بمقبرة باب الفتوح.وتصدى للقيام بأمره ابنه عمر ومال أهل الحل والعقد إلى عمه أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، وكان غائباً بتازا فقدم ثم وقع الصلح بينهما على أن ترك يعقوب الأمر لابن أخيه عمر على أن يكون له تازا وبلادها، ثم وقع الخلف بنيها والتقيا فهزم عمر ثم نزل لعمه يعقوب عن الأمر.ورحل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق فدخل مملكاً، ثم هلك عمر يعد سنة، فكفي يعقوب شأنه واستقام سلطانه، وأخذ في افتتاح أمصار المغرب. وافتتح أمره باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى، ثم قصد إلى مراكش فخرج إليه الخليفة المرتضى من بني عبد المؤمن، وكانت بينهما حرب هزم فيها المرتضى وقتل، وبايع الموحدون أخاه إسحاق ثم قبض عليه سنة أربع وستين وستمائة فقتل فيمن معه، وانقرض أمر بني عبد المؤمن من المغرب.ووصل السلطان أبو يوسف إلى مراكش أول سنة ثمان وستين وستمائة فدخلها، وورث ملك الموحدين بها، ثم رجع إلى فاس بعد أن استخلف على مراكش في شوال من سنته، وشرع في بناء المدينة التي استجدها ملاصقةً لمدينة فاس في شوالٍ سنة أربع وسبعين وستمائة، ونزل فيها بحاشيته وذويه، وغزا في خلال ذلك النصارى بالأندلس أربع مرات حتى أذعن له شانجة بن أدفونش، وسأله في عقد السلم له فعقد له على شروط اشترطها عليه، وعاد إلى بلاد المغرب فمرض ومات في آخر المحرم سنة خمس وثمانين وستمائة.وبويع بعده ابنه ولي عهده أبو يعقوب يوسف بن يعقوب فجرى على سنن أبيه في العدل والغزو، وأجاز إلى الأندلس، وجدد السلم مع شانجة ملك النصارى.وغزا تلمسان مرات وبقي حتى طعنه خصي من خدمه، وهو نائم على فراشه، فمات سابع ذي القعدة سنة ست وسبعمائة.وبويع بعده ابنه أبو ثابت عامر بن أبي يعقوب يوسف واختلف عليه النواحي، ثم استقام أمره وبقي حتى انتقض عليه عثمان بن أبي العلاء، بنواحي طنجة من أقصى الغرب، فخرج لقتاله ومرض في طنجة ومات في ثامن صفر سنة سبع وسبعمائة.وبويع بعده أخوه أبو الربيع بن أبي يعقوب يوسف فأحسن السيرة، وأجزل الصلات، وسار بسيرة آبائه وبقي حتى مات بمدينة تازا في سلخ جمادى الأخرة سنة عشر وسبعمائة ودفن بصحن جامعها.وبويع بعده أخوه أبو سعيد عثمان بن أبي يعقوب يوسف فلما استقام أمره بالغرب الأقصى سار إلى تلمسان سنة أربع عشرة وسبعمائة فانتزعها من موسى ين عثمان بن يغمراس: سلطان بني عبد الواد بها، وانتقض عليه محمد بن يحيى العزفي صاحب سبتة فسار إليه في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فأذعن للطاعة، وأحضر عبد المهيمن بن محمد الحضرمي من سبتة وولاه ديوان الإنشاء والعلامة.وفي أيامه قصد بطرة وجوان ملك النصارى بالأندلس غرناطة. فاستغاثوا به، فأجاز البحر إليهم ولقى عساكر النصارى فهلك بطرة وجوان في المعركة وكانت النصرة للمسلمين، وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة.وبويع بعده ابنه ولي عهده أبو الحسن علي بن عثمان وهو الذي كان في عصر المقر الشهابي بن فضل الله. وسار إلى تلمسان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة، فملكها من ابن أبي تاشفين سلطان بني عبد الواد بها بعد أن قتله بقصره. وملك تونس من يد أبي يحيى سلطان الحفصيين بها في جمادى الأخرة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، واتصل ملكه ما بين برقة إلى السوس الأقصى والبحر المحيط الغربي، ثم استرجع الحفصيون تونس بعد ذلك. وملك بعد ذلك سلجماسة قاعدة بلاد الصحراء بالغرب الأقصى، وبقي حتى مات في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ثنتين وخمسين وسبعمائة بجبل هنتاتة.وبويع بعده ابنه أبو عنان بن أبي الحسن وكان بنو عبد الواد قد استعادوا تلمسان في أيام أبيه فارتجعها منهم في سنة ثلاث وخمسين، ونزل له الأمير محمد ابن أبي زكريا صاحب بجاية عنها فانتظمت في ملكه. وملك قسنطينة من الحفصيين بعد ذلك بالأمان. ثم ملك تونس من أيديهم سنة ثمانٍ وخمسين. ورجع إلى المغرب، فارتجع الحفصيون تونس وسائر بلاد أفريقية وبقي حتى توفي في ذي الحجة سنة تسع وخمسين.وكان ابنه أبو زيان ولي عهده فعدل عنه إلى ابنه السعيد بن أبي عنان واستولى عليه الحسن بن عمرو وزير أبيه فحجبه في داره، واستقل بالأمور دونه.وتغلب أبو حمو سلطان بني عبد الواد على تلمسان فانتزعها من يده في سنة ستين وسبعمائة.ثم خرج على السعيد بن أبي عنان عمه أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن وكان بالأندلس فجاء إليه بالأساطيل، واجتمع إليه العساكر، ووصل إلى فاس، وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد عن الأمر، وأسلمه إلى عمه أبي سالم وخرج إليه فبايعه، ودخل فاس في منتصف شعبان سنة ستين وسبعمائة، واستولى على ملك المغرب، وقصد تلمسان فأجفل عنها أبو حمو سلطان بني عبد الواد فدخلها بالأمان في رجبٍ سنة إحدى وستين وسبعمائة، فأقر بملكها حفيداً من أحفاد بني عبد الواد يقال له أبو زيان، ورجع إلى فاس في شعبان من سنته.وعاد أبو حمو إلى تلمسان فملكها من أبي زيان. وبنى إيواناً فخماً بفاس بجانب قصره، وانتقل إليه، وفوض أمر القلعة إلى عمر بن عبد الله بن علي من أبناء وزرائهم، فعمد إلى أبي عمر تاشفين الموسوس ابن السلطان أبي الحسن فأجلسه على أريكة الملك، وبايعه في ذي القعدة سنة ثنتين وستين وسبعمائة. وأفاض العطاء في الجند.وأصبح السلطان أبو سالم فوجد الأمر على ذلك ففر بنفسه، فأرسل عمر بن عبد الله بن علي في أثره من قبض عليه واحتز رأسه وأتى بها إلى فاس.ثم أنكر اهل الدولة على عمر بن عبد الله ما وقع منه من نصب أبي عمر المذكور لضعف عقله، فأعمل فكره فيمن يصلح للملك فوقع رأيه على أبي زيان محمد ابن الأمير عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن.وكان قد فزع إلى ملك النصارى بإشبيلية من الأندلس، فأقام عنده خوفاً من السلطان أبي سالم، فبعث إليه من أتى به، وخلع أبا عمر من الملك، وبعث إليه بالألة والبيعة من تلقاه بطنجة. ورحل إلى فاس في منتصف شهر صفر سنة ثلاثٍ وستين وسبعمائة، ودخل إلى قصر الملك، فأقام به والوزير عمر بن عبد الله مستبد عليه لا يكل إليه أمراً ولا نهياً وحجره من كل وجه، فثقل ذلك على السلطان أبي زيان، وأمر بعض أصحابه في الفتك بالوزير عمر، فبلغ الخبر الوزير فدخل على السلطان من غير إذن على ما كان اعتاده من، وألقاه في بئر وأظهر للناس أنه سقط عن ظهر فرسه وهو ثمل في تلك البئر.واستدعي من حينه عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن من بعض الدور بالقلعة، فحضر القصر وجلس على سرير الملك، ودخل عليه بنو مرين فبايعوه وكمل أمره، وذلك في المحرم سنة ثمان وستين وسبعمائة، واستبد عليه كما كان مستبداً على من قبله، فحجره ومنعه من التصرف في شيء من أمره، ومنع الناس أن يسألوه في شيء من أمروهم، فثقل ذلك عليه غاية الثقل، وأكنه في نفسه إلى أن استدعاه يوماً فدخل عليه القصر، وكان قد أكمن له رجالأ بالقصر، فخرجوا عليه وضربوه بالسيوف حتى مات.واستقل السلطان عبد العزيز بملكه، وقصد تلمسان فملكها من يد أبي حمو سلطان بني عبد الواد بالأمان بعد إجفال أبي حمو عنها.ودخلها يوم عاشوراء سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة.وارتحل عنها آخر المحرم إلى الغرب ووصل إلى فاس، ثم عاد إلى تلمسان وخرج منها يريد المغرب، فمرض ومات في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعمائة.وبويع بعد ابنه سعيد بن عبد العزيز وهو طفل، وقام بأمره وزيره أبو بكر بن غازي ورجعوا به إلى المغرب ودخل إلى فاس وجددت له البيعة بها، واستبد عليه الوزير أبو بكر، وحجره عن التصرف في شيء من أمره لصغره.ورجع أبو حمو سلطان بني عبد الواد إلى تلمسان فملكها في جمادى سنة أربع وسبعين وسبعمائة.وخرج عليه أبو العباس بن أبي سالم وكان بالأندلس فأجاز البحر وسار إلى فاس فملكها.ودخلها أول المحرم سنة ست وسبعين وسبعمائة، واستقل بملك المغرب، وكان ذلك بموالأة ابن الأحمر صاحب الأندلس فاتصلت بينهما بذلك الصحبة، وتأكدت المودة، وتخلى عن مراكش لعبد الرحمن، وكان بينهما صلح وانتقاض تارةً تارةً، وقصد تلمسان فملكها من أبي حمو بعد فراره عنها، وأقام بها أياماً وهدم أسوارها وخرج منها في أتباع أبي حمو.وخالفه السلطان موسى ابن عمه أبي عنان إلى فاس فملكها، ونزل دار الملك بها في ربيع الأول سنة ست وثمانين وسبعمائة.وقدم السلطان أبو العباس إلى فاس، فوجد موسى ابن عمه قد ملكها ففر عنها إلى تازا، ثم أرسل إلى السلطان موسى بالطاعة والأذعان، فأرسل من أتى به إليه، فقيده وبعث به إلى الأندلس واستقل السلطان موسى بملك المغرب، وتوفي لثلاث سنين من خلافته.وبويع بعده المتنصر ابن السلطان أبي العباس فلم يلبث أن خرج عليه الواثق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من الأندلس، فسار إلى فاس ودخلها وحل بدار الملك بها، وبويع في شوال سنة ثمان وثمانين وسبعماائة.وبعث المنتصر إلى أبيه العباس بالأندلس فأجاز السلطان أبو العباس من الأندلس إلى سبتة، فملكها في صفر سنة تسع وثمانين وسبعمائة، ثم استنزله عنها ابن الأحمر صاحب الأندلس وانتظمها في ملكه.ثم ظهرت دعوة السلطان أبي العباس بمراكش واستولى جنده عليها، ثم سار إليها ابنه المنصر وملكها، وسار السلطان أبو العباس إلى فاس فملكها، ودخل البلد الجديد بها خامس رمضان سنة تسع وثمانين وسبعمائة لثلاثة أعوام وأربعة أشهر من خلعه، وبعث بالواثق إلى الأندلس ثم أمر بقتله فقتل في طريقه بطنجة.وكان أبو حمو صاحب تلمسان قد مات واستولى عليها بعده ابنه أبو تاشفين قائماً بدعوة أبي العباس صاحب فاس، ومات أبو تاشفين وأقيم ابنه طفلاً فيها، ثم قتله عمه يوسف بن أبي حمو، وجهز السلطان أبو العباس ابنه أبا فارس عثمان فملكها وأقام فيها دعوة أبيه، وتوفي السلطان أبو العباس بمدينة تازا في المحرم سنة ست وتسعين وسبعمائة.واستدعوا ابنه أبا فارس فبايعوه بتازا، ورجعوا به إلى فاس، وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمو من الأعتقال وبعثوا به إلى تلمسان.وبقي أبو فارس في مملكة الغرب إلى الآن: وهو السلطان أبو فارس: عثمان ابن السلطان أبي العباس أحمد، ابن السلطان أبي سالم إبراهيم، ابن السلطان أبي الحسن علي، ابن السلطان أبي سعيد عثمان، ابن السلطان أبي يوسف، بن عبد الحق.المقصد الرابع في بيان ترتيب هذه المملكة:وفيه عشر جمل:الجملة الأولى في ذكر الجند وأرباب الوظائف من أرباب السيوف والأقلام ومقادير الأرزاق الجارية عليهم وزي السلطان وترتيب حاله في الملك:أما الجند، فأشياخ كبار وأشياخ صغار، وهم القائمون مقام الأمراء الطبلخانات بمصر على ما تقدم في أفريقية، ولا يعرف بها أميرٌ له عدة كما بمصر والشام وإيران، ولا يطلق اسم الأمرة عندهم على أحد من الجند بحال.ثم بعد الأشياخ عامة الجند من الأندلسيين وغيرهم، والعلوج من الفرنج، على ما تقدم في مملكة أفريقية من غير فرق في الترتيب، والوزراء والقضاة وأرباب الوظائف على نحو ما تقدم في أفريقية.الجملة الثانية في زي السلطان والأشياخ وأرباب الوظائف في اللبس:أما زي السلطان والأشياخ وعامة الجند، فإنهم يتعممون بعمائم طوالٍ، قليلة العرض من كتان، ويعمل فوقها إحرامات يلفونها على أكتافهم، ويتقلدون السيوف تقليداً بدوياً، ويلبسون الخفاف في أرجلهم وتسمى عندهم الأنمقة كما في أفريقية، ويشدون المهاميز فوقها، ويتخذون المناطق وهي الحوائص ويعبرون عنها بالمضمات من فضة أو ذهب.وربما بلغت كل مضمة منها ألف مثقال، ولكنهم لا يشدونها إلا في يوم الحرب أو يوم التمييز: وهو يوم عرضهم على السلطان.ويختص السلطان بلبس البرنس الأبيض الرفيع، لا يلبسه ذو سيف غيره.أما العلماء وأهل الصلاح فإنه لا حرج عليهم في ذلك ولا حرج في غير الملون البيض من البرانس على أحد.وأما زي القضاة والعلماء والكتاب وعامة الناس، فقريبٌ من لبس الجند. إلا أن عمائمهم خضر، ولا يلبس أحد منهم الأنمقة: وهي الأخفاف في الحضر ولا يمنع أحدٌ منهم من لبسها في السفر.الجملة الثالثة في الأرزاق المطلقة من قبل السلطان على أهل دولته:أما رزق الأجناد ففي مسالك الأبصار عن السلايحي: أن للأشياخ الكبار الأقطاعات الجارية عليهم: لكلٍ واحدٍ منهم في كل سنة عشرون ألف مثقالٍ من الذهب، يأخذها من قبائل، وقرى، وضياعٍ، وقلاعٍ، ويتحصل له من القمح والشعير والحبوب من تلك البلاد نحو عشرين ألف وسق.ولكل واحدٍ مع الأقطاع الأحسان في رأس كل سنة وهو حصانٌ بسرجه ولجامه، وسيف ورمحٌ محليان، وسبنية وهي بقجة قماش فيها ثوب طرد وحشٍ مذهب سكندري، ويعبرون عن هذا الثوب بالزردخاناه، وثوبان بياض من الكتان عمل أفريقية، وإحرام وشاشٌ ثمانون ذراعاً، وقصبتان من ملف وهو الجوخ، وربما زيد الأكابر على ذلك، وربما نقص من هو دون هذه الرتبة.وللأشياخ الصغار من الأقطاع والأحسان نصف ما للأشياخ الكبار مع الحصان المسرج الملجم والسيف والرمح والكسوة، ومنهم من لا يلحق هذه الرتبة فيكون أنقص.ومن عدا الأشياخ من الجند على طبقات: فالمقربون إلى السلطان يكون لكل واحدٍ منهم ستون مثقالأة من الذهب في كل شهر، وقليلٌ ما هم، ومن دون ذلك يكون له في الشهر ثلاثون مثقالأ ثم دونها، إلى أن يتناهى إلى أقل الطبقات وهي ستة مثاقيل في كل شهر. وليس لأحدٍ منهم بلد ولا مزدرع.وأما قاضي القضاة، فله في كل يوم مثقالٌ من الذهب، وله أرضٌ يسيرة يزرع بها ما تجيء منه مؤونته وعلف دوابه.وأما كاتب السر، فله في كل يوم مثقالأن من الذهب، وله محيران يعني قريتين يتحصل له منهما متحصل جيد، مع رسوم كثيرة له على البلاد ومنافع وإرفاقات، ولكل واحدٍ من كاتب السر وقاضي القضاة في كل سنة بغلة بسرجها ولجامها، وسبنية قماش برسم كسوته كما للأشياخ.الجملة الرابعة في جلوس السلطان في كل يوم:قال السلايحي: من عادة سلطانهم أن يجلس في بكرة كل يوم، ويدخل عليه الأشياخ الكبار فيسلموا عليه، فيمدلهم السماط ثرائد في جفانٍ حولها طوافير: وهي المخافي، فيها أطعمة ملونة منوعة. ومع ذلك الحلوى: بعضها مصنوع بالسكر، ومعظمها مصنوع بالعسل والزيت، فيأكلون ثم يتفرقون إلى أماكنهم.وربما ركب السلطان بعد ذلك والعسكر معه وقد لا يركب.أما أخريات النهار فإن الغالب أن يركب بعد العصر في عسكره ويذهب إلى نهر هناك.ثم يخرج إلى مكانٍ فسيح من الصحراء، فيقف به على نشز من الأرض، وتتطارد الخيل قدامه، وتتطاعن الأقران، وتمثل الحرب لديه، وتقام صفوفها على سبيل التمرين حتى كأنها يوم الحرب حقيقة. ثم يعود في موكبه إلى قصره، وتتفرق العساكر، وتحضر العلماء وفضلاء الناس وأعيانهم إلى محاضرته حينئذ.فيمد لهم سماطٌ بين يديه فيأكلون ويؤاكلهم، ثم يأخذ كاتب السر في قراءة القصص والرقاع والكلام في المهمات، ويبيت عنده من يسامره من الفضلاء في بعض الليالي، وربما اقتضت الحال مبيت كاتب السر فيبيت عنده.الجملة الخامسة في جلوسه للمظالم:قال السلايحي: قد جرت عادة من له ظلامة أن يرتقب السلطان في ركوبه في موكبه يعني يوم جلوسه للمظالم فإذا اجتاز به السلطان صاح من بعدٍ لا إله إلا الله انصرني نصرك الله! فتؤخذ قصته وتدفع لكاتب السر، فإذا عاد جلس في قبة معينة لجلوسه، ويجلس معه أكابر أشياخه مقلدين السيوف، ويقف من دونهم على بعد، مصطفين متكئين على سيوفهم، ويقرأ كاتب السر قصص أصحاب المظالم وغيرها فينظر فيها بما يراه.الجملة السادسة في شعار السلطان بهذه المملكة:علمها علمٌ أبيضٌ حريرٌ مكتوبٌ عليه بالذهب نسيجاً بأعلى دائره آياتٌ من القرآن، يسمونه العلم المنصور كما في أفريقية، وربما عبر عنه هؤلاء بسعد الدولة، يحمل بين يديه في المواكب.ومنها- أعلام دونه مختلفة الألوان تحمل معه أيضاً.ومنها- سيف ورمح ودرقة. يحملن بين يديه في المواكب أيضاً: يحملها ثلاثةٌ من خاصته من وصفانه أو من أبناء خدم سلفه.ومنها- أطبار تحمل حوله. ويعبرون عنها بالطبرزينات، يحملها أكابر قواد علوجه من الفرنج ورجالٌ من الأندلسيين خلفه وقدامه.ومنها- رماحٌ طوالٌ وقصارٌ. يحملها خمسون رجلاً مشاة بين يديه مشدودي الأوساط بيد كل واحد منهم رمحان: رمحٌ طويل ورمحٌٌ قصير، وهو متقلد مع ذلك بسيف.ومنها- الجنائب. وهي خيل تقاد أمامه، عليها سروج مخروزة بالذهب كالزركش وركبها ذهبٌ كل ركاب زنته ألف دينار، ووعليها ثياب سروج من الحرير مرقوقة بالذهب، ويعبرون عن الجنائب بالمقادات، وعن ثياب السروج بالبراقع.ومنها- الطبول تدق خلف ساقته وهي من خصائص السلطان ليس لأحدٍ من الناس أن يضرب طبلة غيره حتى يمنع من ذلك أصحاب الحلق.ومنها- البوقات مع الطبل على العادة.الجملة السابعة في ركوبه لصلاة العيد:قال السلايحي: وفي ليلة العيدين ينادي والي البلد في أهلها بالمسير، ويخرج أهل كل سوقٍ ناحية، ومع كل واحدٍ منهم قوس أو آلة سلاح، متجملين بأحسن الثياب، ويبيت الناس تلك الليلة أهل كل سوق بذاتهم خارج البلد، ومع أهل كل سوق علم يختص بهم، عليه زنك أهل تلك الصناعة بما يناسبهم.فإذا ركب السلطاتن بكرة اصطفوا صفوفاً يمشون قدامه، ويركب السلطان ويركب العسكر معه ميمنةٍ وميسرة والعلوج خلفه ملتفون به، والأعلام منشورة وراءه، والطبول خلفها حتى يصلي ثم يعود، فينصرف أرباب الأسواق إلى بيوتهم، ويحضر طعام السلطان خواصه وأشياخه.الجملة الثامنة في خروج السلطان للسفر:ومن عادة هذا السلطان إذا سافر أن يخرج من قصره وينزل بظاهر بلده، ثم يرتحل من هناك فيضرب له طبلٌ قبيل الصبح إشعاراً بالسفر، فيتأهب الناس ويشتغل كل أحد بالأستعداد للرحيل.فإذا صلى صلاة الصبح ركب الناس على قبائلهم في منازلهم المعلومة، ووقفوا في طريق السلطان صفاً إلى صف، ولكل قبيل رجلٍ علمٌ معروف به ومكانٌ في الترتيب لا يتعداه، فإذا صلى السلطان الصبح قعد أمام الناس، ودارت عليه عبيده ووصفائه ونقباؤه، ويجلس ناسٌ حوله يعرفون بالطلبة يجري عليهم ديوانه، يقرأون حزباً من القرآن، ويذكرون شيئاً من الحديث النبوي، على قائله أفضل الصلاة والسلام!.فإذا أسفر الصبح ركل وتقدم أمامه العلم الأبيض المعروف بالعلم المنصور، وين يديه الرجالة بالسلاح والخيل المجنوبة، بثياب السروج الموشية، ويعبرون عن ثياب السروج بالبراقع. وإذا وضع السلطان رجله في الركاب، ضرب على طبلٍ كبير يقال له تريال ثلاث ضربات إشعاراً بركوبه. ثم يسير السلطان بين صفي الخيل ويسلم كل صفٍ عليه بأعلى صوته سلامٌ عليكم ويكتنفانه يميناً وشمالأ، وتضرب جميع الطبول التي تحت البنود الكبار الملونة خلف الوزير على بعدٍ من السلطان، ولا يتقدم أمام العلم الأبيض إلا من يكون من خواص علوج السلطان، وربما أمرهم بالجولان بعضهم على بعض، ثم ينقطع ضرب الطبول إلى أن يقرب من المنزل.وإذا ركب السلطان لا يسايره إلا بعض كبار الأشياخ من بني مرينٍ أو بعض عظماء العرب، وإذا استدعى أحداً لا يأتيه إلا ماشياً، ثم ربما حدثه وهو يمشي، وربما أكرمه فأكرمه بالركوب. فإذا قرب السلطان من المنزل تقدمت الزمالة: وهم الفراشون، ويضربون شقة من الكتان في قلبها جلود يقوم بها عصيٌ وحبالٌ من القصب في أوتاد، وتستدير على كثيرٍ من الأخبية وبيوت الشعر الخاصة به وبعياله وأولاده الصغار، تكون هذه الشقة كالمدينة لها أربعة أبواب في كل جهةٍ بابٌ، وهذه الشقة هي المعبر عنها في الديار المصرية بالحوش، ويحف به عبيده وعلوجه ووصفانه، ويضرب للسلطان أمام ذلك قبةٌ كبيرةٌ مرتفعةٌ من كتانٍ تسمى قبة الساقة لجلوس الناس فيها وحضورهم عنده بها، وهذه هي التي تسمى بمصر المدورة.وإذا عاد السلطان إلى حضرة ملكه ضربت البشائر سبعة أيام، وأطعم الناس طعاماً شاملاً في موضعٍ يسع كافتهم.الجملة التاسعة في مقدار عسكر هذه المملكة:قال في مسالك الأبصار: سألت أبا عبد الله السلايحي عن عدة هذا العسكر في سلطنة أبي الحسن المريني، وكان ابن جرار قد قال إن عسكره مائة ألف وأربعون ألفاً- فقال: الذي نعرفه قبل فتحه تلمسان أن جريدته المثبتة في ديوانه لا تزيد على أربعين ألف فارس غير حفظة المدن والسواحل، إلا أنه يمكنه إذا استجاش لحربٍ عليه أن يخرج في جموعٍ كثيرة لا تكاد تنحصر، وأنه يمكن أن يكون قد زاد عسكره بعد فتح تلمسان مثل ذلك.الجملة العاشرة في مكاتبات السلطان:قال في مسالك الأبصار: جرت العادة أنه إذا انتهى الكاتب إلى آخر الكتاب وكتب تاريخه، كتب السلطان بخطه في آخره ما صورته وكتب في التاريخ المؤرخ به ونقل عن السلايحي أن ذلك مما أحدثه أبو حفص عمر المريني عم السلطان أبي الحسن في سلطنته، وتبعه السلطان أبو الحسن على ذلك مع وثوقه بكاتب سره حينئذ: الفقيه الفاضل أبي محمد عبد المهيمن بن الحضرمي واعتماده عليه ومشاركته له في كل أمره.
|